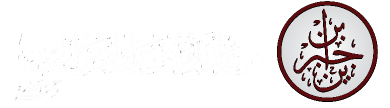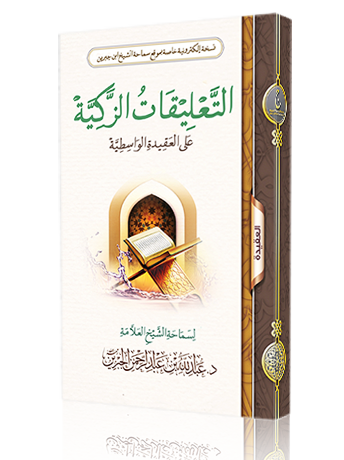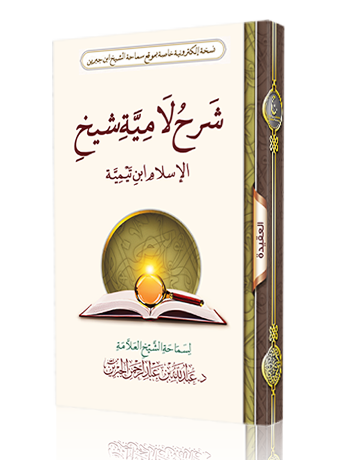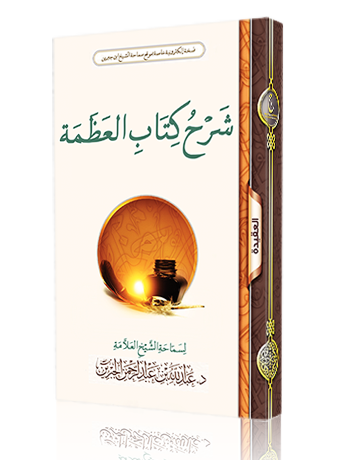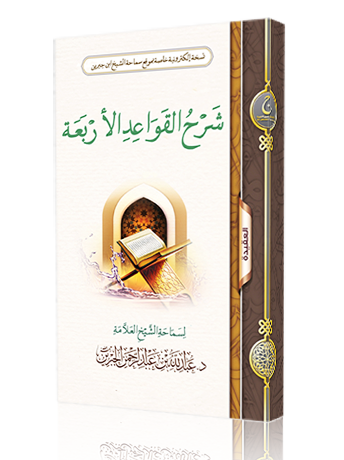التعليقات على متن لمعة الاعتقاد

([فصل] في الإيمان بالقدر)
ص (ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور).
س 38 (أ) ما الإيمان بالقدر. (ب) وما حكمه. (ج) وما معنى كونه الفعال لما يريد. (د) وما الفرق بين المشيئة والإرادة. (هـ) وما المراد بتقديره وتدبيره. (و) وما معنى لا محيد لأحد عن القدر المقدور (ز) وما اللوح المسطور؟.
ج 38 (أ) الإيمان بالقدر هو اعتقادنا أن الله علم ما سيعمله الخلق قبل أن يوجدهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وقدر وحدد لكل منهم عمره وأجله، وأنه الذي أعطاهم قوة وقدرة على الأعمال، وأنه لا يكون في الوجود حركة أو سكون إلا بإرادة الله ومشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فله المشيئة النافذة، والقدرة الشاملة، لجميع ما في الكون.
(ب) وهذا أحد الأركان الستة للإيمان، فمن لم يؤمن به ومات على ذلك فهو متوعد بالنار، كما في سنن أبي داود وغيره عن عبادة بن الصامت أنه أوصى ابنه عند الاحتضار بالإيمان بالقدر، ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يا بني إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار.
(ج) قوله (الفعال لما يريد). بيان لكمال تصرفه، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يخرج عن أرادته شيء، ولا يستعصي على تدبيره أمر.
(د) والمشيئة والإرادة هنا بمعنى واحد، أي لا يحدث في الوجود حركة ولا سكون إلا بعد أن يريده الله إرادة خلق وتقدير، فلا أحد من الخلق يقدر على أن يتغلب على الله، ويخرج عن مشيئته.
(هـ) وهكذا معنى تقديره وتدبيره. أي لا يستطيع أحد الخروج عما قدره الله عليه، وكل ما حدث أو سيحدث من قول أو فعل فقد علمه الله، وقدر حدوثه، فلم يصدر إلا بعد تدبيره وتكوينه.
(و) ولا محيد. أي لا مفر ولا محيص لأحد عن المقدر، المكتوب عليه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض فلا يتعدى ما جرى به القلم في أم الكتاب.
(ز) والمراد باللوح المسطور. اللوح المحفوظ المذكور في القرآن، وقد روي في بعض الآثار أنه من درة بيضاء، وأنه واسع وكبير، وقد كتب الله فيه مقادير الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض.
س 39 (أ) من المخالف في هذا الباب. (ب) واذكر أقسام الإرادة مع الدليل والتمثيل.
ج 39 (أ) ظهر في آخر عهد الصحابة قوم أنكروا القدر السابق، ويعرفون بغلاة القدرية، كمعبد الجهني وغيلان القدري فأنكروا العلم الأزلي، ونفوا كتابة الحوادث قبل حدوثها، وقالوا: إن الأمر أنف. أي مستأنف. وقد كفرهم السلف، وحذروا منهم، كما روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقال الإمام الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله.
ثم حدث بعدهم المعتزلة، كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأنكروا قدرة الله على أفعال العباد، وزعموا أن الله لا يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، وأن قدرة المخلوق على أفعاله تغلب قدرة الله تعالى، وقد أنكر عليهم السلف، وبينوا ضلالهم، وقد روي في السنن عن جابر مرفوعا تسميتهم بمجوس هذه الأمة؛ لأن فعلهم هذا شرك، بل هو أول شرك حدث في الإسلام.
(ب) وأما الإرادة فهي في كتاب الله قسمان: 1- إرادة كونية قدرية، يدخل فيها كل الموجودات، من طاعات ومعاص. 2- إرادة دينية شرعية، تتعلق بالطاعات المأمور بها، سواء وجدت أو لم توجد، فالأولى بمعنى المشيئة، وهي عامة لكل ما وجد فيقال في الطاعات: إن الله أرادها وقدر وجودها، وأحبها فوجدت. وفي المعاصي: إن الله أرادها كونا وقدرا وخلقها فوجدت، مع أنه نهى عنها ولم يحبها. وأما الثانية فهي بمعنى محبة المراد، والرضا به، ولا يلزم منها وجود المراد، فإيمان المؤمنين، وأعمالهم التي قد عملوها، تعلقت بها الإرادتان، حيث إن الله شاءها وخلقها فوجدت، وأحبها ورضيها فمدح أهلها؛ وإيمان الكافر لم يوجد مع أن الله قد أحب منه الإيمان، وأمره به شرعا، ولكنه ما أراده قدرا، ولا خلقه فيه، ولا أعانه، فلم يتعلق به إلا الإرادة الدينية الشرعية.
فالكونية يلزم منها وجود المراد، وقد يكون محبوبا، كإيمان المؤمن، أو مكروها ككفر الكافر.
والشرعية يلزم منها محبة المراد، والمدح على فعله، ولا يلزم وجوده، فهو تعالى أحب إيمان المؤمن، وأراده شرعا وقدرا فوجد، وأحب إيمان الكافر، وأراده شرعا، ولم يرده قدرا فلم يوجد.
ودليل الشرعية قوله تعالى
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ 
 وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ 
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ  [النساء]،
[النساء]،  إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  [المائدة].
[المائدة]. ودليل القدرية قوله تعالى:
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا  [الأنعام]، وقوله:
[الأنعام]، وقوله:  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ  [البقرة].
[البقرة].