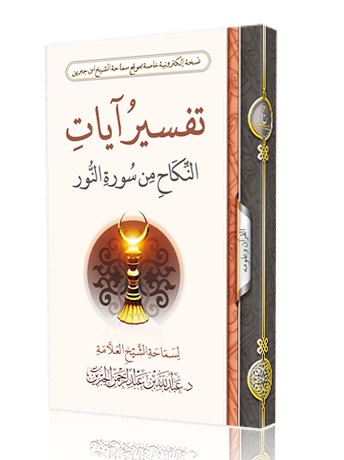تفسير سورة الحجرات من تفسير ابن كثير

تفسير قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا) إلى قوله تعالى: (فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تسليما كثيرا.
حيا هذا في روضة من رياض الجنة؛ روضة ذكر، نسأل الله أحبتي في الله ألا يفرقنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهاهو يتجدد اللقاء بسماحة الوالد، نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  قبله:
قبله:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم  .
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد عرفنا أن هذه السورة من السور المكية، وأنها مشتملة على كثير من الأحكام، ومن الأحكام التي اشتملت: النهي عن التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويدخل في ذلك: التقدم على أقواله؛ من الأحكام: غض الصوت عنده، وكذا غض الصوت عند كلامه. من الأحكام: النهي عن الجفاء والغلظ في ندائه من وراء الحجرات، وأن هذا يدخل فيه أيضا: التقدم بين يدي سنته، وعدم احترامها، ونحو ذلك.
من الأحكام: ما ذكر في هذه الآية؛ وهو التثبت في الأخبار ؛ سيما إذا كان ذلك المخبر ليس موثوقا بل يتهم بالفسوق:
 إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا  وفي قراءة: ( فتثبتوا )
وفي قراءة: ( فتثبتوا )  أَنْ تُصِيبُوا
أَنْ تُصِيبُوا  أي: مخافة أن تصيبوا،
أي: مخافة أن تصيبوا،  قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  أي: تتسرعون فتصيبوهم، ولا يكونون مستحقين لتلك الإصابة فتصبحوا نادمين على ما فعلتم.
أي: تتسرعون فتصيبوهم، ولا يكونون مستحقين لتلك الإصابة فتصبحوا نادمين على ما فعلتم. ذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبوه من الذين قتلوا في بدر أو قتلوا في الطريق بين بدر والمدينة ؛ لأنه كان من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم.
أسلم هو، ثم إنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الصدقة؛ ليجبي الزكاة من بني المصطلق، وكانوا قد أسلموا، وتزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية؛ فكانوا قد أسلموا، وحسن إسلامهم. فلما أقبل إليهم لأخذ الزكاة فقد استقبلوه؛ قابلوه في الطريق؛ فخيل إليه أنهم يقتلونه؛ لإحن قديمة بينهم في الجاهلية، فرجع هاربا إلى المدينة وقال: منعوا الزكاة، وكادوا يقتلونني، كادوا أن يقتلوني، فصدقوه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، واجتمع الصحابة، وقالوا: إذا منعوا الزكاة فإنا نغزوهم؛ حتى نقبض منهم، وبينما هو كذلك إذ جاء وفدهم؛ وفد بني المصطلق، وقالوا: يا رسول الله، إننا استقبلنا رسولك، وإنه رجع بعدما قابلنا، فقال: هل منعتم؟. قالوا: ما منعنا وإنما فرحنا بقدومه فعند ذلك نزلت الآية وفيها التثبت، إذا جاءكم إنسان بخبر، وذلك الإنسان ليس بثقة؛ يتهم بالتسرع؛ فعليكم أن تتثبتوا في خبره، وعليكم أن تتأنوا ولا تعجلوا؛ حتى تظهر لكم حالتهم وحالة ما جاءكم به من الخبر، وتعرفوا هل ما جاء به صحيح أم ليس بصحيح.
هذا هو السبب أعني: الأمر بالتثبت،
 فَتَبَيَّنُوا
فَتَبَيَّنُوا  أو ( فتثبتوا ) فيقال: عن كل من جاء بخبر؛ فإن كان ذلك المخبر موثوقا عدلا ثبتا في خبره قبل خبره، وإن كان معروفا بالتسرع، أو غير ثقة؛ كما ذكر في هذه الآية؛ وصفه بأنه فاسق؛ يعني: خارج عن العدالة؛ فلا تقبلوا خبره، بل تبينوا؛ يتبين لكم الخبر الحقيقي وتعرفوا صحة ما جاء به أو خطأه في ذلك؛ حتى لا تتسرعوا؛ مخافة
أو ( فتثبتوا ) فيقال: عن كل من جاء بخبر؛ فإن كان ذلك المخبر موثوقا عدلا ثبتا في خبره قبل خبره، وإن كان معروفا بالتسرع، أو غير ثقة؛ كما ذكر في هذه الآية؛ وصفه بأنه فاسق؛ يعني: خارج عن العدالة؛ فلا تقبلوا خبره، بل تبينوا؛ يتبين لكم الخبر الحقيقي وتعرفوا صحة ما جاء به أو خطأه في ذلك؛ حتى لا تتسرعوا؛ مخافة  أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  يعني: أن تغزوا قوما بموجب ذلك الخبر، وتقتلوهم وتقاتلوهم؛ وهم مسلمون ليسوا من أهل الكفر والفسوق ونحو ذلك.
يعني: أن تغزوا قوما بموجب ذلك الخبر، وتقتلوهم وتقاتلوهم؛ وهم مسلمون ليسوا من أهل الكفر والفسوق ونحو ذلك. وقد نزل مثل هذه الآية في سورة النساء، كان بعض الصحابة غزاة في سرية، فمر بهم رجل يسوق غنما فسلم عليهم؛ فقالوا: هذا ليس بمسلم ما هذا إلا كافر؛ فتسرعوا وقتلوه؛ مع أنه قد سلم عليهم وأظهر الإسلام، فلما قتلوه أخذوا غنمه؛ فأنزل الله تعالى:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  يعني: سافرتم في سبيل الله،
يعني: سافرتم في سبيل الله،  فَتَبَيَّنُوا
فَتَبَيَّنُوا  أو ( فتثبتوا )
أو ( فتثبتوا )  وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا  يعني: تكذبونه إذا قال: السلام عليكم؛ بل اقبلوا منه،
يعني: تكذبونه إذا قال: السلام عليكم؛ بل اقبلوا منه،  لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  تريدون أخذ غنيمته، وهي من عرض الحياة الدنيا،
تريدون أخذ غنيمته، وهي من عرض الحياة الدنيا،  فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ  يغنيكم عن هذه الغنيمة؛ ما قتلتموه إلا رغبة في ماله:
يغنيكم عن هذه الغنيمة؛ ما قتلتموه إلا رغبة في ماله:  كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ  قد كنتم من قبل على الكفر؛ فهداكم الله تعالى. فهذا؛ لعله قد هداه الله، وأنتم تسرعتم،
قد كنتم من قبل على الكفر؛ فهداكم الله تعالى. فهذا؛ لعله قد هداه الله، وأنتم تسرعتم،  كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا  أو ( فتثبتوا ) يعني: لا تعجلوا؛ فدل على أن من جاء بخبر ووقع الشك في خبره؛ فلا يجوز التسرع فيه، ولا يجوز أن يقبل قوله لأول مرة، بل يتثبت في خبره، والمعنى: مخافة
أو ( فتثبتوا ) يعني: لا تعجلوا؛ فدل على أن من جاء بخبر ووقع الشك في خبره؛ فلا يجوز التسرع فيه، ولا يجوز أن يقبل قوله لأول مرة، بل يتثبت في خبره، والمعنى: مخافة  أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  يعني: أن تبطشوا بهم وتقتلوهم عن جهل تظنون صدق ذلك الخبر.
يعني: أن تبطشوا بهم وتقتلوهم عن جهل تظنون صدق ذلك الخبر.  فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  أي تندمون بعدما يقع الخبر، بعدما يقع قتلهم أو سبيهم، وتعرفون بعد ذلك أنهم لا يستحقون؛ فتندمون بعدما يفوت الأوان
أي تندمون بعدما يقع الخبر، بعدما يقع قتلهم أو سبيهم، وتعرفون بعد ذلك أنهم لا يستحقون؛ فتندمون بعدما يفوت الأوان  فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  .
.  وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ  يعني: من بينكم؛ فلا تعجلوا حتى تشاوروه، ولا تتسرعوا بالأمر قبل أن يأمركم به. وإذا شاوركم فاعرضوا عليه ما تريدون، ولا تعرضوا عليه قبل أن يشاوركم؛
يعني: من بينكم؛ فلا تعجلوا حتى تشاوروه، ولا تتسرعوا بالأمر قبل أن يأمركم به. وإذا شاوركم فاعرضوا عليه ما تريدون، ولا تعرضوا عليه قبل أن يشاوركم؛  وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  .
. كثير منهم يشيرون؛ ويقولون: أرسلنا إلى كذا، أرسلنا إلى غزوة كذا وكذا، أو اقتل هذا، أو احبس هذا، أو اضرب هذا، أو اقطع يده أو نحو ذلك، أو هذا منافق فاقتله، أو هذا قد نافق أو ما أشبه ذلك.
يقترحون أمورا قد يكون فيها شيء من التسرع؛ نظرا إلى حدتهم وشدتهم وغيرتهم على حدود الله تعالى، فيقول: عليكم أن تتثبتوا وألا تعجلوا فإن:
 فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ  وهو أعلم منكم. ولو يطيعكم في كثير من الأمور التي تقترحون وتشيرون بها لوقعتم في عنت.
وهو أعلم منكم. ولو يطيعكم في كثير من الأمور التي تقترحون وتشيرون بها لوقعتم في عنت.  لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  العنت هو الشدة والمشقة والصعوبات. أي: وقعتم في صعوبات؛ فقد يقتل بريء، وقد يكفر مؤمن، وقد يسلب مسلم، وما أشبه ذلك، ذلك بلا شك من آثار التسرع.
العنت هو الشدة والمشقة والصعوبات. أي: وقعتم في صعوبات؛ فقد يقتل بريء، وقد يكفر مؤمن، وقد يسلب مسلم، وما أشبه ذلك، ذلك بلا شك من آثار التسرع.  لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ  العنت؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لأمته قال الله تعالى:
العنت؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لأمته قال الله تعالى:  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  يعني: شاق عليه الشيء الذي يعنتكم، يعني: يكلفكم ويضركم.
يعني: شاق عليه الشيء الذي يعنتكم، يعني: يكلفكم ويضركم. فكذلك
 لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ  .
. هذه ميزة للصحابة، وشهادة لهم بأن الله تعالى حبب إليهم الإيمان؛ ملأ به قلوبهم. الإيمان الصحيح الذي هو الإيمان بالله والإيمان ببقية الأركان؛ وذلك لأنهم رأوا الآيات، وشاهدوا عجائب المخلوقات، ونظروا إلى المعجزات وإلى الآيات البينات؛ فامتلأت قلوبهم بالإيمان، وأحبوا الإيمان وأحبوا الأعمال الصالحة التي هي نتيجة الإيمان؛ فالله تعالى حببه إليهم؛ حتى رغبوا فيه وصاروا مؤمنين. وهذه نعمة كبيرة، وميزة للصحابة الذين حبب الله إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم.
يدخل في الإيمان: الأعمال الصالحة، يعني: حبب إليكم الصلوات والصدقات والأذكار والأدعية، والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله، والتفكر في آيات الله تعالى، والإحسان إلى عباد الله، والنصيحة للمؤمنين. حبب إليكم آثار الإيمان، وزينه في قلوبكم؛ حتى امتلأت قلوبكم بذكر الله تعالى وبالإيمان به.
 وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ  أي: بغض إليكم الكفر بأنواعه: الكفر العملي والكفر الاعتقادي؛ فكرهتموه. وذلك لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة، إذا امتلأ القلب بالإيمان؛ نفر القلب عن الكفر، أبغض الكفر وأبغض أهله وابتعد عنه وعن أسبابه؛ فيبغض سب الدين، ويبغض الشرك بأنواعه، ويكره المعاصي والمحرمات؛ بغض
أي: بغض إليكم الكفر بأنواعه: الكفر العملي والكفر الاعتقادي؛ فكرهتموه. وذلك لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة، إذا امتلأ القلب بالإيمان؛ نفر القلب عن الكفر، أبغض الكفر وأبغض أهله وابتعد عنه وعن أسبابه؛ فيبغض سب الدين، ويبغض الشرك بأنواعه، ويكره المعاصي والمحرمات؛ بغض  وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  .
. قد يقال: إنه لا فرق كثير بين الفسوق والعصيان، ولكن من باب تنويع العبارات، قد عرفنا أن الكفر هو الجحد والإنكار؛ إنكار وحدانية الله، وإنكار استحقاقه للعبادة، وإنكار فرائضه التي فرضها.
الفسوق: الأصل فيه الخروج؛ يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، وكل شيء خرج عن طبعه فإنه فسوق. ويسمى العصاة: فاسقين، والمعاصي: فسوقا. فذكر الله تعالى أنواعًا من المعاصي وسماها فسوقا؛ من ذلك قوله تعالى:
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  . جعل هذه المضارة فسوقا. ومنها: ما يأتينا في هذه السورة؛ قوله تعالى:
. جعل هذه المضارة فسوقا. ومنها: ما يأتينا في هذه السورة؛ قوله تعالى:  وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ  ؛ ذلكم فسق.
؛ ذلكم فسق.  بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  فسماه فسوقا. يعني: التنابز
فسماه فسوقا. يعني: التنابز  بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ  .
. ومنها: استحلال بعض المحرمات في قوله تعالى:
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ  إلى قوله:
إلى قوله:  ذَلِكُمْ فِسْقٌ
ذَلِكُمْ فِسْقٌ  بعد قوله:
بعد قوله:  وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  فجعل الاستقسام وما أشبهه؛ جعله فسقا.
فجعل الاستقسام وما أشبهه؛ جعله فسقا. ومنها: الذبح لغير الله؛ قال تعالى:
 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  .
. فجعل الذبح لغير الله فسقا مع أنه شرك، وفي الحديث:
 لعن الله من ذبح لغير الله
لعن الله من ذبح لغير الله  .
. وأنواع الفسوق كثيرة، وقد يصل إلى الكفر؛ قال تعالى:
 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا  فجعل الله تعالى هذا العمل كفرا بعد قوله:
فجعل الله تعالى هذا العمل كفرا بعد قوله:  أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ  .
. فهذا من أنواع الفسوق؛ فالله تعالى كره إلى الصحابة الفسوق؛ بحيث إنهم مقتوه وإنهم أبغضوا الفسوق. وكذلك العصيان أي جميع المعاصي. وهذا من علامات الخير. كون الإنسان يكره المعاصي وينفر منها طبعه ويبغضها، ويبغض أهلها؛ فإن هذا من أسباب محبة الخير.
إذا أبغض الشر أحب الخير؛ فيقول الله تعالى:
 وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  يعني: جعلها ثقيلة في نفوسكم تكرهونها وتبغضونها، وتبغضون أهلها، ومن المعلوم أنك إذا أحببت المعاصي كرهت الطاعة، وإذا أبغضت المعاصي أحببت الطاعة. فأما أن تكون محبا لهما؛ فلا. لا يمكن أن الإنسان يحب الطاعة والمعصية جميعا؛ بل لا بد أن يحب إحداهما أكثر من الأخرى؛ فهذا دليل على ما فضل الله تعالى به الصحابة من هذه الميزة، ثم نقول ليس هذا خاصا بالصحابة بل غيرهم. من كان كذلك فإنه منهم؛ ولهذا يستحب لك أن تدعو؛ أن تدعو بهذه الآية؛ فتقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين؛ حتى تحصل لك هذه الميزة، تحب الإيمان ويمتلأ به قلبك والأعمال الصالحة، وتنفر من الكفر وتبغضه وتبغض أهله، وتنفر أيضا من الفسوق، وتمقت العصاة والفسقة وتبغضهم وتبتعد عنهم.
يعني: جعلها ثقيلة في نفوسكم تكرهونها وتبغضونها، وتبغضون أهلها، ومن المعلوم أنك إذا أحببت المعاصي كرهت الطاعة، وإذا أبغضت المعاصي أحببت الطاعة. فأما أن تكون محبا لهما؛ فلا. لا يمكن أن الإنسان يحب الطاعة والمعصية جميعا؛ بل لا بد أن يحب إحداهما أكثر من الأخرى؛ فهذا دليل على ما فضل الله تعالى به الصحابة من هذه الميزة، ثم نقول ليس هذا خاصا بالصحابة بل غيرهم. من كان كذلك فإنه منهم؛ ولهذا يستحب لك أن تدعو؛ أن تدعو بهذه الآية؛ فتقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين؛ حتى تحصل لك هذه الميزة، تحب الإيمان ويمتلأ به قلبك والأعمال الصالحة، وتنفر من الكفر وتبغضه وتبغض أهله، وتنفر أيضا من الفسوق، وتمقت العصاة والفسقة وتبغضهم وتبتعد عنهم. روي عن بعض السلف كذي النون المصري ؛ أنه قيل: له متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. يعني: إذا كانت المعاصي كريهة عندك؛ كل المعاصي؛ ولو كانت تهواها النفس؛ ولو كانت تميل إليها وتحبها؛ فإن علامة المؤمن أن يكره المعاصي، أن يكون الله كره إليه الفسوق والمعاصي؛ بحيث إنها تنفر منها نفسه. النفوس بطبعها تميل إلى بعض مشتهياتها؛ فتميل النفس ضعيفة الإيمان إلى محبة سماع الغناء والتلذذ من حبه، وإلى محبة شرب الخمر والتلذذ بطعمه، وإلى محبة الزنا والتلذذ به وما أشبه ذلك. ولكن إذا علم المؤمن بأن الله حرمه؛ فإنه ينفر منه، ويبتعد عنه، ويكرهه كراهة شديدة.
هكذا يكون المؤمن؛ إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. ذكر أن ابن عمر مرة كان في سفر، فمر براعي غنم ومعه زمارة يزمر بها لغنمه؛ فسد أذنيه؛ حتى لا يسمع صوت الزمارة، وما زال يمشي إلى أن ابتعد، فقال لنافع هل تسمع صوتها؟ قال: لا. فعند ذلك فتح أذنيه. هناك من يتلذذ بصوتها؛ صوت المزامير ونحوها، ولكن المؤمن حقا يتأفف منها، وينفر منها، ولا يحبها. لا شك أن هذا دليل على أن الله إذا حبب إلى الإنسان الإيمان؛ كره إليه الكفر والفسوق والمعاصي.
 أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ  الرشد: ضد الغي، الإنسان إما راشدا وإما غاويا؛ يقول الله تعالى:
الرشد: ضد الغي، الإنسان إما راشدا وإما غاويا؛ يقول الله تعالى:  قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  فجعلهما متقابلين، وذكر أن هناك من يؤثر الغي؛ يقول الله تعالى:
فجعلهما متقابلين، وذكر أن هناك من يؤثر الغي؛ يقول الله تعالى:  وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا  فأهل الرشد: هم أهل الرشاد المسترشدون، الذين أرشدهم الله يعني: دلهم وهداهم، وأهل الغي هم المنحرفون ...
فأهل الرشد: هم أهل الرشاد المسترشدون، الذين أرشدهم الله يعني: دلهم وهداهم، وأهل الغي هم المنحرفون ... فالله تعالى جعل هؤلاء من الراشدين؛ فكل من آمن بالله إيمانا كاملا، وأحب الإيمان وامتلأ به قلبه، وكره الكفر والفسوق والمعاصي؛ فإنه حري أن يوصف بالرشد؛ أن يكون من الراشدين.
ثم قال:
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم  ؛ دل على أن هذا فضل الله؛ أنه تفضل على عباده، ولما تفضل عليهم كان من آثار هذا الفضل أنه: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم.
؛ دل على أن هذا فضل الله؛ أنه تفضل على عباده، ولما تفضل عليهم كان من آثار هذا الفضل أنه: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. الفضل والتفضل: هو المن على من يشاء، تفضل عليكم يعني: من عليكم؛ من عليكم بأن:
 حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ  وفضلكم بأن زينه في قلوبكم، وفضلكم بأن كره إليكم الكفر والفسوق والمعاصي؛ العصيان؛ فمن كان كذلك فإنه من الراشدين، ومن نقص من ذلك فإنه من الغاوين؛ لم يتصف بمحبة الإيمان ولا ببغض الكفر؛ يخاف عليه أنه من جملة الغاوين؛ الغاوي هو ضد الراشد. ومن كان غاويا فإنه تهوي به غوايته إلى الضلال.
وفضلكم بأن زينه في قلوبكم، وفضلكم بأن كره إليكم الكفر والفسوق والمعاصي؛ العصيان؛ فمن كان كذلك فإنه من الراشدين، ومن نقص من ذلك فإنه من الغاوين؛ لم يتصف بمحبة الإيمان ولا ببغض الكفر؛ يخاف عليه أنه من جملة الغاوين؛ الغاوي هو ضد الراشد. ومن كان غاويا فإنه تهوي به غوايته إلى الضلال.  فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  تعالى،
تعالى،  وَنِعْمَةً
وَنِعْمَةً  منه.
منه.  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وفي هذه الآية أو هذه الآيات من الفوائد: التثبت في الأخبار، وأن الإنسان لا يتسرع إذا سمع خبرا؛ فكل ما سمعت من الأخبار لا تنقله، ولا تقول: سمعت كذا وكذا؛ فقد يكون بعض الأخبار غير صحيح، قد يتكلم البعض في بعض المجالس عن طريق الظن؛ فيقول: حدث كذا ووقع كذا، وهو يظن ظنا؛ و
وفي هذه الآية أو هذه الآيات من الفوائد: التثبت في الأخبار، وأن الإنسان لا يتسرع إذا سمع خبرا؛ فكل ما سمعت من الأخبار لا تنقله، ولا تقول: سمعت كذا وكذا؛ فقد يكون بعض الأخبار غير صحيح، قد يتكلم البعض في بعض المجالس عن طريق الظن؛ فيقول: حدث كذا ووقع كذا، وهو يظن ظنا؛ و  الظن أكذب الحديث
الظن أكذب الحديث  .
. وفيها بيان أن العدل يقبل قوله ولو كان واحدا يحتج بها على قبول خبر الواحد أو خبر الآحاد؛ خلافا لبعض المعتزلة والإباضية ونحوهم؛ فإنهم يردون خبر الواحد. يردون الأحاديث التي في الصحيح، ويقولون: إنها أخبار آحاد، ولا نقبلها، ويتسلطون على الأحاديث التي في الصفات؛ فيردونها، ويقولون -ولو كانت في الصحيح- إنها أخبار آحاد؛ فلا نقبلها؛ مع أن الأمة تلقتها بالقبول. في هذه الآية: قبول خبر الواحد إذا كان عدلا.
وفيها أن التسرع قد يؤدي إلى الندم
 أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  وفيها: أن الصحابة عليهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان بين أظهرهم، وأن عليهم ألا يتسرعوا بالقول قبله، وألا يأمروه بأمر لم يكن ثبتا، وأنهم قد يقعون في العنت إذا أطاعهم في شيء من هذه الأمور التي يقترحونها.
وفيها: أن الصحابة عليهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان بين أظهرهم، وأن عليهم ألا يتسرعوا بالقول قبله، وألا يأمروه بأمر لم يكن ثبتا، وأنهم قد يقعون في العنت إذا أطاعهم في شيء من هذه الأمور التي يقترحونها. ثم فيها أيضا: فضيلة الصحابة. زكاهم الله؛ حيث ذكر أنه حبب إليهم الإيمان، وهذه ميزة عظيمة. وفيها بيان أن الإيمان ما تمتلئ به القلوب
 وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ  يعني: امتلأت به؛ وهو دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون ؛ أي: يكون بعضهم أقوى إيمانا من بعض؛ فخلافا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان واحد، والناس كلهم مستوون. فالإيمان أهله في أصله سواء، لا فرق بين إيمان جبريل والملائكة، وبين إيمان أفسق الناس؛ وهذا من الخطأ؛ فالله تعالى ذكر أنه زين الإيمان في قلوبهم يعني: رسخه حتى صار قويا راسخا.
يعني: امتلأت به؛ وهو دليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون ؛ أي: يكون بعضهم أقوى إيمانا من بعض؛ فخلافا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان واحد، والناس كلهم مستوون. فالإيمان أهله في أصله سواء، لا فرق بين إيمان جبريل والملائكة، وبين إيمان أفسق الناس؛ وهذا من الخطأ؛ فالله تعالى ذكر أنه زين الإيمان في قلوبهم يعني: رسخه حتى صار قويا راسخا. وفيها أيضا: أن المعاصي تتفاوت حيث بدأ بالكفر وهو أكبر المعاصي، ثم بالفسوق لأنه قد يطلق على الكفر، ثم بالعصيان وهو أخفها. فبدأ بالأصعب الذي هو الكفر
 وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  .
. وفيها: بيان أن هداية المؤمنين بفضل الله ؛ أنه هو الذي تفضل عليهم، ومع ذلك فإن هناك أسبابا للهداية؛ قال تعالى:
 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ؛ فجعل للهداية أسبابا؛ فيتبين أن من أتى بالأسباب وفقه الله تعالى، وهناك أيضا أسباب خارجية وهي من غيره؛ يعني: أنك قد تدعوه فتكون دعوتك سببا إن كان الله تعالى هو الذي يقذف الإيمان في قلبه، وقد يستمع إلى قصة، أو يستمع إلى قراءة قارئ، أو يحضر خطبة، أو نحو ذلك مما يكون سببا في هدايته. فلا جرم نقول: إن الفضل من الله تعالى؛ ومع ذلك فإنه جعل له أسبابا، نقرأ الآية بعدها.
؛ فجعل للهداية أسبابا؛ فيتبين أن من أتى بالأسباب وفقه الله تعالى، وهناك أيضا أسباب خارجية وهي من غيره؛ يعني: أنك قد تدعوه فتكون دعوتك سببا إن كان الله تعالى هو الذي يقذف الإيمان في قلبه، وقد يستمع إلى قصة، أو يستمع إلى قراءة قارئ، أو يحضر خطبة، أو نحو ذلك مما يكون سببا في هدايته. فلا جرم نقول: إن الفضل من الله تعالى؛ ومع ذلك فإنه جعل له أسبابا، نقرأ الآية بعدها. 
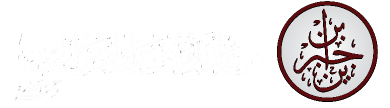








 تعدد التفاسير
تعدد التفاسير