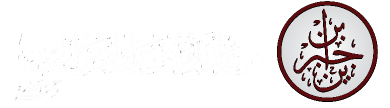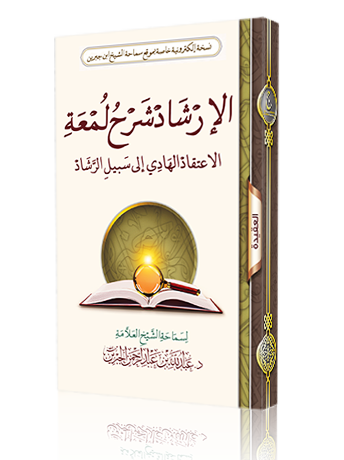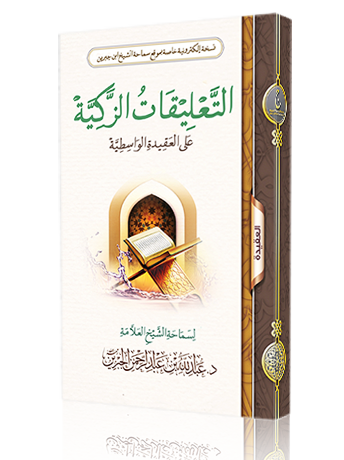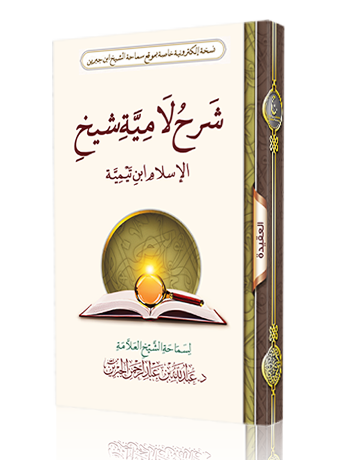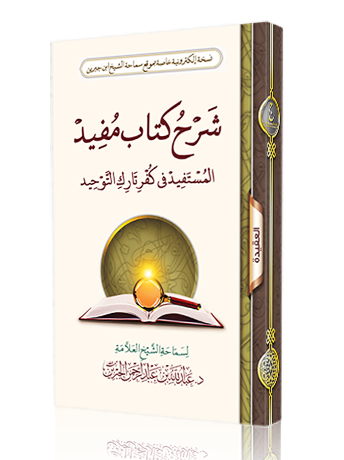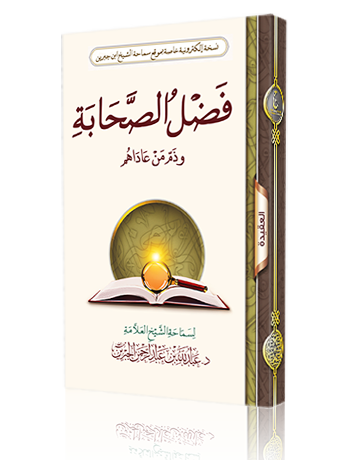تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب

من شروط كلمة التوحيد: المحبة
...............................................................................
وأما الشرط الخامس: فهو المحبة. المؤمن يُحِبُّ الله، ويحب رسوله. وكذلك يُحِبُّ عبادة الله، ويحب أهل الله، وأولياء الله، وإذا أحب الله تعالى تعبد له، وإذا أحب العبادة تقرب بها، وإذا أحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أطاعه واتبعه، وإذا أحب العبادة أكثر منها، وإذا أحب العبادة أبغض ضدها.. وهو المعصية.
فمحبة الله -تعالى- ومحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ومحبة عبادته من أوجب الواجبات على المسلم، عليه أن يقدم محبة الله ونبيه على كل محبة. تعرفون الحديث الذي في الصحيحين؛ قول النبي -صلى الله عليه وسلم-
 ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يُحِبَّ المرءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَفَ في النار
ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يُحِبَّ المرءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَفَ في النار  وهذه الثلاث متلازمة.. إذا حصلت واحدة منها تبعتها الأخريات، فالأصل.. هو المحبة الأولى؛ التي هي: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما.
وهذه الثلاث متلازمة.. إذا حصلت واحدة منها تبعتها الأخريات، فالأصل.. هو المحبة الأولى؛ التي هي: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما. وقد أمر الله -تعالى- بتقديم محبته على محبة كل شيء؛ على محبة الأموال، والبنين، ونحوها، تقرءون قول الله تعالى:
 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  .
. ذكر الله هذه الأصناف الثمانية تفصيلا، والمراد: ما سوى الله، أي: مَنْ قَدَّمَ محبة غير الله على محبته، صدق عليه هذا الوعيد:
 فَتَرَبَّصُوا
فَتَرَبَّصُوا  مثَّلَ الله -تعالى- بالأقارب:
مثَّلَ الله -تعالى- بالأقارب:  آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ  ثم مثَّلَ بمتاع الدنيا:
ثم مثَّلَ بمتاع الدنيا:  وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا  يعني: مِنْ متاع الدنيا، فإذا قَدَّمْتُمْ شيئا من هذه الثمانية على محبة الله، ومحبة نبيه، ومحبة الجهاد في سبيله، والعمل له؛ فإنكم مُتَوَعَّدُون بذلك الوعيد الشديد.
يعني: مِنْ متاع الدنيا، فإذا قَدَّمْتُمْ شيئا من هذه الثمانية على محبة الله، ومحبة نبيه، ومحبة الجهاد في سبيله، والعمل له؛ فإنكم مُتَوَعَّدُون بذلك الوعيد الشديد. ثم نقول: إن هناك الكثير يَدَّعُون محبة الله، ويَدَّعُون محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولكن نقول لهم: أين علامات المحبة؟! وأين آثار هذه المحبة؟! إنما هي دعوى!!
| والدَّعَـاوى إن لم يُقِيمُوا عليهـا | بَيِّنَـاتٍ, أَرْبَـابُهـا أَدْعِـيَــاءُ ! |
رُوِيَ عن بعض السلف أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يُوافِقْهُ فدعواه باطلة.
الموافقة هي: اتباع ما أمر الله، وطاعته، وامتثال الأوامر، وترك المناهي. هذا حقيقة الموافقة.
وسُئِلَ ذو النُّونِ المصري قال له رجل: متى أُحِبُّ ربي؟ قال: إذا كان ما يُبْغِضُهُ أَمَرَّ عندك من الصبر.
وهذا كمثال، يعنى: أن الإنسان إذا أحب الله تعالى.. كره المحرمات، وأبغضها، وابتعد عنها؛ ولو كانت لذيذةً عند النفس، فينفر منها، ويَشْمَئِزُّ من سماعها، فيكره الغناء؛ لأنه مُحَرَّمٌ؛ ولو أن النفس تميل إلى سماعه، ويكره الزنا؛ ولو كانت النفس تَلْتَذُّ به، ويكره المسكرات؛ ولو كانت أَشْرِبَةً لذيذة، وهكذا جميع المحرمات.. تكون مُبَغَّضَةً عنده، أَمَرَّ عنده من الصبر.
يقول بعض المشائخ: إذا كان ما يبغضه أَمَرَّ عندك من الصبر.. كان ما يُحِبُّهُ أحلى عندك من العسل. بمعنى: أن المؤمن الذي يُحِبُّ الله -تعالى- يتلذذ بطاعته، يجد للطاعة حلاوة، يجد لها طلاوة، يجد لها لَذَّةً في قلبه، ولذةً في بدنه، أَلَذَّ من السَّلْوَى، ألذَّ من العسل. وهذا هو الذي وقع لكثير من المؤمنين الأتقياء الذين يتلذذون بالطاعة؛ وعلى رأسهم.. النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه يلتذ بالعبادة، فُرِوَي عنه أنه قال: الظمآن يروى، والجائع يشبع، وأنا لا أشبع من الصلاة ؛ وذلك لأنها محبوبة عند الله -تعالى- فيرى محبتها؛ ولو كانت ثقيلةً على النفس، وكذلك أتباعه -صلى الله عليه وسلم- يتلذذون بقيام الليل؛ ولو كان فيه تعب؛ ولو كان فيه سهر، ومشقة، وصعوبة، يتلذذون به، ويجدون له راحة في نفوسهم. فهذا دليل على أن المحبة أَثَرٌ من آثار الإيمان، وأن مَنْ أَحَبَّ الله -تعالى- أطاعه وامتثل أمره.
ومن علامات محبته -كما عرفنا- بُغْضُ ما يكرهه الله، وما حَرَّمَهُ. فمن أحب أعداء الله فليس بصادق في أنه يحب الله؛ ولذلك يقول: ابن القيم في النونية:
| أَتُحِبُّ أعــداءَ الحبيب, وتـدعي | حُبًّـا له؟! مـا ذاك في الإمكـانِ |
| حُبُّ الْقُـرَانِ, وحُبُّ ألحـان الغنا | في قلب عبـدٍ ليس يجتمعـــانِ |
| تَعْصِي الإله, وأنت تَزْعُـمُ حُبَّـهُ؟! | هذا عجـيب في الفعـال بــديعُ! |
| لو كـان حبك صادقــا لأطعتـه | إن المحـب لمـن يحب مطيــعُ |
فنقول له: إن هذا كاَذِبٌ، كَذَبَ في هذه الأقوال؛ فإن من أحب الله امتثل أوامره، مَنْ أَحَبَّ الله أطاعه، وكذلك مَنْ أَحَبَّ الله كره معصيته، من أحب الله ابتعد عن المحرمات، وتقرب إليه بالطاعات، دليل ذلك من الحديث الذي ذكرنا، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-
 وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَفَ في النار
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَفَ في النار  فكثير من الصالحين يُعَذَّبُون.. ولا يشركون بالله! يقال لهم: إما أن تطيعنا في عبادة غير الله؛ وإلا أحرقناك، ومَزَّقْنَا لحمك! فيصبر على الإحراق وعلى تمزيق اللحم دون أن يطيعهم في معصية الله؛ حتى ولو كانت من المعاصي التي دون الكفر؛ لو أُكْرِهَ على الزنا لَصَبَر ولو عُذِّبَ، وكذلك لو أُكْرِهَ على شرب الخمر لَصَبَرَ على الإكراه ولو قُتِلَ.
فكثير من الصالحين يُعَذَّبُون.. ولا يشركون بالله! يقال لهم: إما أن تطيعنا في عبادة غير الله؛ وإلا أحرقناك، ومَزَّقْنَا لحمك! فيصبر على الإحراق وعلى تمزيق اللحم دون أن يطيعهم في معصية الله؛ حتى ولو كانت من المعاصي التي دون الكفر؛ لو أُكْرِهَ على الزنا لَصَبَر ولو عُذِّبَ، وكذلك لو أُكْرِهَ على شرب الخمر لَصَبَرَ على الإكراه ولو قُتِلَ. وهكذا بقية المعاصي؛ لأنه يعرف أنه لا قدرة له على غضب الله، ولا على مقته، ولا على عذابه، فيقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سخط الناس أهون من سخط الله؛ لأني إذا أسخطُّ ربي عاقبني عقوبة ليس تنتهي، وهي عقوبة الآخرة، وأما عقوبة أهل الدنيا فنهايتها الموت، والموت لا بد منه، فيتحمل ويصبر.
ومن العجب أن كثيرا من أهل البدع ومن أهل الشرك، يصبرون على العذاب الذي يُعَذَّبون به؛ لأجل أن يتركوا شركهم؛ ومع ذلك يتمسكون به. فكثيرا من النصارى يتمسك بنصرانيته؛ ولو قُطِّعَ لحمه، وكثيرا من اليهود يتمسك بيهوديته، وكثيرا من الرافضة يتمسك برافضيته؛ ولو عُذِّبَ؛ ولو أُوذِيَ؛ ولو جُلِدَ؛ ولو قُطِّعَتْ أوصاله ما تحول عن عقيدته، زَيَّنَ الشيطان لهم هذه العقيدة! وهذا الشرك.
وإن كثيرا من المؤمنين الذين هم ضِعَاف الإيمان -فمثل هؤلاء لا شك أنهم لضعف إيمانهم- ينجرفون مع أول من يدعوهم؛ ولو لم يكن هناك إكراه؛ وإنما هو تسويل، وتزيين! فيتركون طاعة الله وعبادته، ويعبدون أهواءهم، وشهواتهم، ودنياهم، ويتركون عبادة الله -تعالى- وطاعته.