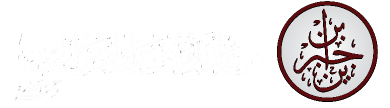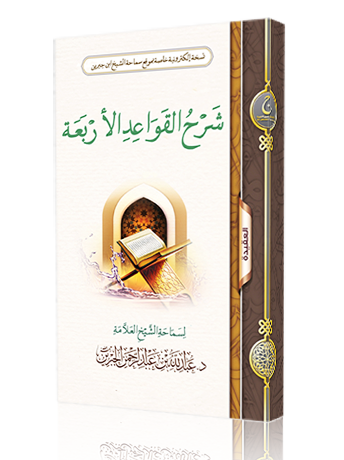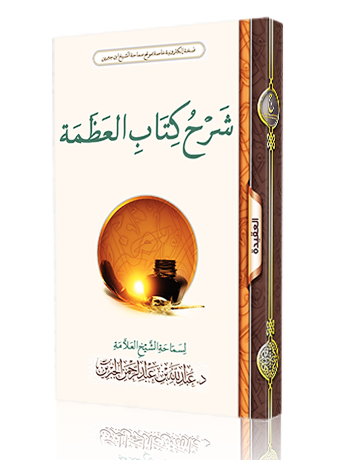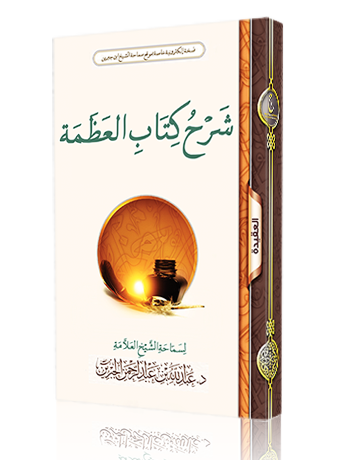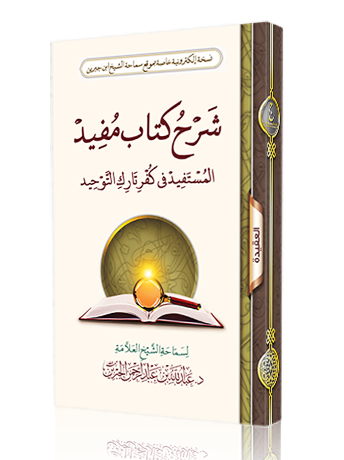تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب

النصارى والقبوريون
...............................................................................
فهؤلاء الذين ينخون عيسى يعني: يدعونه، ويهتفون به، والملائكة، والأولياء. يقصدون: أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم، وكذلك الذين ينخون الأموات في هذه الأزمنة، ينخون –مثلا- الجيلاني أو البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو حتى النبي -صلى الله عليه وسلم- نقول لهم: إنكم مثل النصارى في زعمهم أن عيسى ينفعهم، فهم ينخون عيسى وأنتم تنخون أقل من عيسى.
النصارى سماهم الله مشركين في قوله تعالى:
 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ  -سبحانه عما يشركون- سماهم مشركين؛ لأنهم اتخذوا هؤلاء أربابا، واتخاذهم أربابا: تعظيمهم في الحياة؛ لكونهم يطيعونهم فيما حرم الله، يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال؛ فيكونون بذلك قد أطاعوهم في معصية الله تعالى، فجعلهم الله مشركين:
-سبحانه عما يشركون- سماهم مشركين؛ لأنهم اتخذوا هؤلاء أربابا، واتخاذهم أربابا: تعظيمهم في الحياة؛ لكونهم يطيعونهم فيما حرم الله، يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال؛ فيكونون بذلك قد أطاعوهم في معصية الله تعالى، فجعلهم الله مشركين:  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ  الأحبار: علماء اليهود
الأحبار: علماء اليهود  وَرُهْبَانَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ  العباد في النصارى.
العباد في النصارى. فيوجد في النصارى من يعبد الله الليل والنهار -أي- طوال وقته، زاهدا في الدنيا، متقشفا، متقللا منها، يرضى منها بخشن الطعام، وبأقل اللباس، خشن اللباس، يلبس الثياب الخشنة، وما أشبهها.
كذلك أيضا يزهد في الدنيا، إذا جاءه شيء من المصالح الدنيوية ما تملكه، يتصدق به، يتصدق بكل ما يدخل عليه، منفردا، بعيدا عن الناس، يبنون لهم منازل رفيعة يسمونها صوامع -يعني- مرتفعة كالمنارات، ثم يغلق على نفسه طوال وقته، يقرأ في الإنجيل، يذكر الله، يدعوه، يصلي طوال ليله، وأكثر نهاره، معتزلا في صومعته، يسمونه راهبا -أي- مترهبا؛ حيث إنه لترهبه وتقشفه خضع واعتزل عن الناس.
فلما كان يدعو عيسى ويعبده، ويتواضع له، ويكثر من دعائه، ويقول: إنه ينفعني، وإنه يشفع لي، وإنه.. وإنه..، فهل نفعته عبادته هذه في هذه الصومعة؟ وهل يخفف عنه العذاب؟ لا يخفف عنه؛ بل الأصل أنه كافر بفعله هذا؛ لاعتقاده أن عيسى هو الله، أو اعتقاده أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة؛ ولو لم يعتقد هذا؛ ولكن اعتقد أن عيسى ينفع من دعاه، وأنه يجيب من سأله، أو لم يعتقد ذلك؛ ولكن دعا عيسى وقال: يا عيسى ابن مريم يا كلمة الله.. يا روح الله.. أنقذني، خذ بيدي، أنا العبد الذليل، أنا المتواضع، أنت عضدى وساعدي. فإذا كان كذلك.. فإننا نحكم بكفره.
ثم نقول: يشبهه كثير من القبوريين؛ من المتصوفة ونحوهم، نعرف أن كثيرا منهم عباد، زهاد، يصومون، ويصلون، ويتهجدون بالليل، ويتطوعون، ويتصدقون، ويكثرون من ذكر الله في كل الحالات، ومن دعائه، وعندهم أوراد كثيرة يقرءونها في الصباح والمساء. فيه أوراد صوفية في رسالة اسمها: دلائل الخيرات يدعون بها صباحا ومساء؛ وإن كان أكثر الدعاء بها فيه غلو، وفيه -أيضاً- رسالة أخرى يدعون بها، ويكثرون من الدعاء بها، ورسائل -أيضا- أخرى. لا شك أنهم يقصدون من الدعاء بها: التقرب إلى الله.
فإذا عرفنا أنهم مع ذلك يدعون هذا الولي، ويتوسلون به، ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله، قلنا لهم: أشبهتم النصارى، وأشبهتم المشركين في أعمالهم التي عملوها، فلا فرق بينكم وبينهم؛ إلا في الأسماء.
وقلنا: كتبكم هذه التي تقرءونها وتوردونها ننصحكم بعدم قراءتها؛ لما فيها من البدع، رسالة اسمها: روض الرياحين، ورسالة اسمها: دلائل الخيرات، وأشباهها. فيها غلو وزيادة، الذين كتبوها يغلب عليهم الجهل، ويريدون بذلك أن يقبل الناس على قراءتها، فلما بالغوا فيها، في وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي الصلاة عليه، وفي وصف بعض الصحابة كعلي و الحسن و الحسين ونحوهم، كان ذلك نوع غلو، وزيادة في المدح في هذه الرسائل؛ مما سببت الغلو الفعلي بعد الغلو القولي؛ فإنهم زادوا في مدحهم؛ بحيث يقولون –مثلا- السلام عليك يا عالم الأمة، السلام عليك يا منبع العلوم، عليك الصلاة والسلام يا من بيده الملك والنفع والضر، عليك الصلاة والسلام يا من يقدم ويؤخر، عليك السلام يا من ينفع ويضر، يا من يعلم ما في الكون، يا من يعلم ما كتبه القلم في اللوح، يا من يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهكذا.
مبالغات لا تخطر بالبال -يعني- كيف جمعوها؟! أوحى الشيطان إليهم؛ حتى كتبوها، وسجلوها في هذه الكتب. ثم كان من آثارها: أنهم اعتقدوا ما دلت عليه، فاعتقدوا أن هذا الولي، أو هذا السيد أنه يعلم الغيب والشهادة، وأنه يطلع على ما في الضمائر، وأنه يعلم القريب والبعيد، وأنه قد أطلعه الله على مكنون علمه، وأنه قد تعلق قلبه بالملأ الأعلى، ورأى ما في الكون من العجائب، واطلع على ما كتبه الله -تعالى- في الأزل من الكتابات ومن الكائنات وكلها؛ وإذا كان كذلك.. فلا بد أن له مكانة ورفعة، فلماذا لا نطلب منه؟ وندعوه؟ ونعتمد عليه؟ ونتوسل به؟ ونعطيه من العبادة ما نقدر عليه؟ حتى يفيدنا، وينفعنا، ويشفع لنا. هذه فكرتهم.
ما كانت هذه المدائح موجودة في عهد الصحابة، ما نقلت عن أحد من علماء التابعين، ولا من سلف الأمة، ولا قالها ولا تعبد بها الأئمة الأربعة، ولا أتباعهم الصالحون حين أخذوا عنهم؛ وإنما لما اشتدت غربة الإسلام في القرن العاشر أو التاسع وما بعده، وضعف التوحيد في قلوب المؤمنين، وقلَّ العلماء الصالحون، وصار أكثر العلماء منحرفين في العقيدة إلى أشعرية أو معتزلة أو رافضة أو مرجئة أو متصوفة؛ عند ذلك.. أوحى الشيطان إلى أوليائه، إلى هؤلاء الذين هم ضعفاء الإيمان، وضعفاء العقيدة.
لماذا لا تحببون محمدا إلى الناس؟! يذكرون له أورادا في أوصافه؛ حتى يحبوه، وأنتم يا رافضة اذكروا أوصافا لعلي ؛ حتى يعظموه أتباعكم؛ وحتى يعترفوا بفضله، وهكذا أيضا اذكروا أوصافا للأولياء الذين توالونهم، وصفوهم بأوصاف بليغة رفيعة؛ ليكون ذلك أدعى إلى أنهم يعترفون لهم بالفضل، يعترفون لهم بالمكانة، يوافقونكم فيما تعتقدونه فيهم.
فكان من أسباب ذلك: وجود هذه الرسائل التي قصدوا بها مضاهاة النصارى واليهود والمشركين الأولين الذين تعبدوا بهذه العبادات التي هي شرك في الحقيقة.
فإذا كان هذا كافرا، هذا النصراني الذي يعبد الله ليلا ونهارا، والذي يزهد في الدنيا، ويتقشف، ويتصدق بكل ما جاءه منها، ويعتزل الناس، وينفرد في بناية له خاصة، صومعة أو كنيسة أو دير يعتزل فيه، وأن عباداته هذه لا تفيد ولا تقبل منه، وأنه في الحقيقة كافر؛ حيث إن عباداته دخلها ما أفسدها وهو الشرك بالله؛ فلذلك نعتقد أنه كافر، وأنه مخلد في النار، لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى تنفع عبادته، وتنفع دعوته.
فيقال كذلك الذين يعتقدون في الجيلاني أو في الرفاعي أو في النقشبندي أو في التيجاني أو نحوهم، يعتقدون فيه أنه يطَّلع على الكون، وأنه يعلم الغيب، ويعلم ما في الضمير، وأنه يعطي من دعاه، ويجيب من سأله، وينفع من استنفعه، وأنه أهل أن يعبد، وأن يُصْرف له كل ما يمكن صرفه له، وأن دعاءه هو الذي ينفع، فتركوا عبادة ربهم الذي خلقهم وعبدوا غيره، فصاروا بذلك مثل النصارى، أو شرا من النصارى؛ لأن عيسى رسول من رسل الله، وأما عبد القادر و التيجاني و الجيلاني و الرفاعي ونحوهم؛ فإنهم لم يصلوا إلى رتبة عيسى ولا أقل منها؛ ولو سموهم أولياء، أو صحابة، أو نحو ذلك.
ثم نقول: ربنا –سبحانه- هو المعبود وحده، هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. فهؤلاء الذين يصرفونها لغيره يعتبرون قد أشركوا، وهم -أيضا- قد تنقصوا ربهم تنقصا زائدا؛ فإن الشرك تنقص لله تعالى.
هم يدّعون أنهم يعظمون الله، كيف تعظيمكم لله؟! يقولون: تعظيمنا لله.. أننا لا ندعوه مباشرة؛ لأننا مذنبون، وضعفاء، محجوبون، مبعدون، فكيف نتجرأ أن نطلب من الله مباشرة؟! إنما نعظم الله؛ فنجعل بيننا وبينه واسطة، فنقول: واسطتنا الأنبياء، أو الأولياء، والشهداء، ونحوهم، نجعل هؤلاء وسائط.
فالجواب: أن هذا ليس تعظيما؛ وإنما هو تنقص؛ لأنكم بذلك تتهمون الله تعالى، أو تصفونه بأنه لا يسمع من دعاه، ولا يعطي من سأله، وأنه يحتاج إلى من يتوسط بين العباد وبينه، ويحتاج إلى من ينقل له أحوال خلقه، وفي ذلك تنقص عظيم. فالرب -تعالى- لا يقاس بملوك الأرض؛ وذلك لأنهم يحتاجون إلى من يعرفهم بخلقه، وأما الرب -تعالى- فلا يحتاج إلى من يعرفه؛ بل هو عالم بكل شيء.