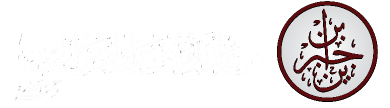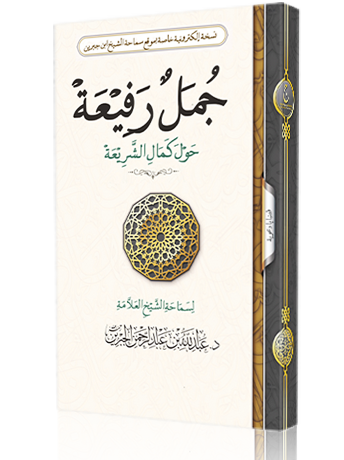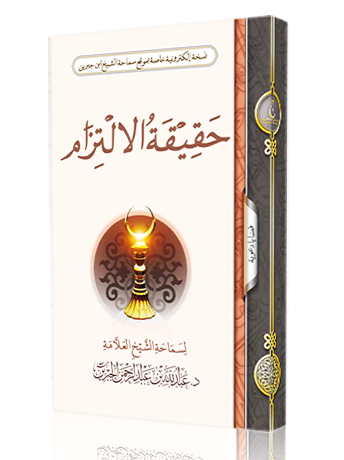جمل رفيعة حول كمال الشريعة

تضمن شرع الله ورسالة رسوله بيان العبادات المجملة
ولما كانت العبادة مجملة لا دخل للعقل في معرفة مفرداتها وأمثلتها؛ تضمن شرع الله ورسالة رسوله بيانها وإيضاح أنواعها، فبين لهم العبادات البدنية، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف في المساجد ونحوها، وشرح لهم جميع متعلقاتها، وأركانها وشروطها، وصفاتها التي تكون بها مجزئة تبرأ بها الذمة، وتسلم من العهدة، كما بين لهم النوافل منها، ورغبهم في الإكثار من القربات التي يترتب عليها جزيل الثواب، وهكذا حثهم على العبادات القولية؛ فأمرهم بذكره ودعائه تضرعًا وخفية، وبتلاوة كتابه، وبالدعوة إلى دينه، كما أمر بأداء العبادات المالية، فأخبرهم بما يجب عليهم في أموالهم من زكاة ونذر وصدقة ونفقة، وبما لهم من الثواب إذا تبرعوا له بشيء من أموالهم فأنفقوه في سبيله.
وهكذا أوضح لهم سائر القربات التي هي حقه على العباد وبها يتحقق وصفهم بالعبودية له وحده، ولم يقتصر على هذا القدر من البيان بل تطرق إلى أمورهم المالية الأخرى، وأوضح لهم وجوه المكاسب ومداخل الأموال، وما يحلّ منها وما لا يحل، وحرم علهم الكثير من المعاملات التي تحتوي على ضرر بالغير من سُكر ورِشوة وربا وغش وسرقة ونهب وغصب، إلخ.. وأباح لهم سائر المكاسب التي لا شبهة في حلها، وهكذا تطرق إلى بقية الأحكام المالية؛ فأوضح ما يحل منها وما لا يحل.
ولم يقف البيان الشرعي عند هذا الحد، بل بين الله في رسالة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أحكام العقود التي لها صلة بالغير من المسلمين أو غيرهم، كعقد الذمة والأمان والصلح والمعاهدات، وعقد النكاح وملك اليمين، وما يتصل بذلك للحاجة الضرورية في هذه الحياة إلى أمثال ذلك.
وهكذا أيضا شرع الحدود والعقوبات البدنية والمالية ؛ لما لها من الآثار الملموسة في استتباب الأمن واستقرار الحياة، وذلك أن من طبع الإنسان -إلا من عصم الله- الميل إلى الشهوات والملذات -ولو محرمة- أو إلى الأشَرِ والبطر، أو إلى الظلم والاعتداء، أو إلى السلب والنهب، والسرقة والاختلاس، ونحو ذلك، فلو تُرك هؤلاء وميولهم لاختل الأمن، وعُدمت الطمأنينة في الحياة، وانتشرت الفوضى، وأصبح الضعيف نهبة للقوي، وسيطر الظلمة الطغاة على البلاد والعباد، وأعلنوا كفرهم وبغيهم وفجورهم، بدون خوف أو مبالاة.
فكان من حكمة الرب -جل وعلا- أن شرع من الزواجر والعقوبات ما يقمع أهل الشرور والمعاصي، فمن ارتد عن دينه وكفر بعد إسلامه؛ لم يقر على ذلك بل حده القتل بكل حال، إن لم يتب عن ردته، ومن تعاطى السحر أو الشعوذة أو عمل الكهانة ونحو ذلك شرع قتله قبل أن يستشري فساده في البلاد، مما ينافي حكمة الرب -تعالى- ومن بغى على إمام المسلمين وخرج عن طاعته وفارق جماعة المسلمين لزم قتاله بعد الدعوة والمراجعة وبيان أنه إن مات كذلك مات ميتة جاهلية.
كما أمر -عز وجل- بالصلح بين الطائفتين المقتتلتين وقتال الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله، وأخبر أنهم مع هذا التقاتل لم يخرجوا عن الأخوة الإيمانية، وهكذا كتب القصاص، كما في قوله -تعالى-  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى  كما كتبه على أهل التوراة في النفس فما دونها، قال -تعالى-
كما كتبه على أهل التوراة في النفس فما دونها، قال -تعالى-  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  وبين الحكمة والمصلحة في شرعية ذلك كما في قوله -تعالى-
وبين الحكمة والمصلحة في شرعية ذلك كما في قوله -تعالى-  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  فأخبر أن في شرعية القصاص حفظ النفوس؛ حيث إن القاتل متى تذكر أنه سيقتل أحجم وارتدع عن القتل؛ فتقل هذه الجريمة ويحصل الأمن على الحياة.
فأخبر أن في شرعية القصاص حفظ النفوس؛ حيث إن القاتل متى تذكر أنه سيقتل أحجم وارتدع عن القتل؛ فتقل هذه الجريمة ويحصل الأمن على الحياة.
وهذا هو السر -أيضًا- في شرعية الجزاء الرادع للمحاربين لله ورسوله الذين يسعون في الأرض فسادًا، وهم الذين يقطعون الطريق ويعترضون سابلة المسلمين في الأسفار؛ لأخذ الأموال، أو هتك الأعراض، ونيل الشهوات المحظورة شرعًا، قال الله -تعالى-  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  وكل ذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء، والإبقاء على نفوسهم؛ ليهنئوا بالعيش، وتقر أعينهم في هذه الحياة، ويبعد عنهم كل ما يكدر صفو عيشهم وأمنهم واستقرارهم، فمن ثم يتفرغون للعلم والعمل والتفقه؛ فيما يلزمهم لربهم من الحقوق والعبادات، وليقوموا بالواجبات فيما بينهم.
وكل ذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء، والإبقاء على نفوسهم؛ ليهنئوا بالعيش، وتقر أعينهم في هذه الحياة، ويبعد عنهم كل ما يكدر صفو عيشهم وأمنهم واستقرارهم، فمن ثم يتفرغون للعلم والعمل والتفقه؛ فيما يلزمهم لربهم من الحقوق والعبادات، وليقوموا بالواجبات فيما بينهم.
وهكذا أيضًا تضمنت الشريعة الإسلامية الزجر الشديد عن جرائم الذنوب وكبائر الفواحش، كالزنا وشرب الخمر وقذف الأبرياء المحصنين، وسرقة الأموال، ونحو ذلك؛ فإن جريمة الزنا فاحشة كبرى وفعلة شنعاء تستبشعها النفوس الأبية، وتنفر منها الطباع السليمة الرفيعة؛ لما فيها من انتهاك الحرمات، وإفساد الفرش، واختلاط الأنساب، وتفكك الأسر، ويسبب ميل الزوجة عن زوجها إلى الأخدان الخائنين في السر، والتقصير في حق الزوج وفي إصلاح بيتها وتربية أطفالها، ورعايتها لمن استرعاها الله من أهل بيتها، ونحو ذلك من الفساد، ومثل ذلك وأعظم، يقع في حق الزوج متى وقع في تعاطي هذه الفاحشة النكراء، فلا جرم أن كانت عقوبة الزنا في هذه الشريعة أعظم من غيرها؛ حيث شرع رجم الزاني أو الزانية مع الإحصان بالحجارة حتى الموت؛ ليتم الزجر والقمع لتلك النفوس المريضة بالشهوة البهيمية، وخص المحصن بالرجم حيث إنه قد كفر النعمة وعدل عن الحلال وتعاطى الحرام، برغم ما فيه من إفساد فرش الناس وتعرض زوجته للعهر، والميل إلى فعل هذه الفاحشة مع غيره، ونحو ذلك من المفاسد، بخلاف غير المحصن فإن عقوبته الجلد والتغريب، وهي دون الرجم بالحجارة؛ لخفة ذنبه بالنسبة للمحصن، لقوة الغلمة والشهوة التي قد تغلبه فيضعف إيمانه وتصديقه بالوعيد عن قمعها، فتعرض نفسه الأمارة بالسوء فيقع في هذه الجريمة.
وهكذا أيضًا عاقب الذين يرمون المحصنات عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة، فقال -عز وجل-  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  وهذه عقوبات عاجلة، وقال -تعالى- عن عقوبتهم الآجلة:
وهذه عقوبات عاجلة، وقال -تعالى- عن عقوبتهم الآجلة:  إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  الآيات، ذلك أن مقترفي هذا الفعل والذنب الكبير يقدحون في الأنساب، وينتهكون الأعراض البريئة، وينشرون لأولئك الأبرياء سمعة سيئة؛ تقشعر منها الجلود، وتنكس منها الرؤوس حياء وخجلا، مع بعدهم عن تلك الجرائم المزعومة ونزاهتهم عن اقترافها؛ فكانت عقوبة من قذفهم بها الجلد ورد الشهادة، والحكم عليهم بالفسق الذي هو الخروج عن العدالة والطاعة مع استحقاقهم للعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وللعذاب العظيم في الدار الآخرة، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا لهم عن الكذب والافتراء على المؤمنين والاستهتار، والهتك للأعراض؛ فيأمن الناس ويطمئنون في حياتهم، وتتم بينهم المودة والإخاء، وتزول العداوة والشحناء؛ مما يكون سببًا للتقاطع والتدابر والتهاجر الذي جاء الشرع بالنهي عنه وتحريمه؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من اختلال الأمن، ووقوع الفتن، وتسلط الأعداء ونحو ذلك.
الآيات، ذلك أن مقترفي هذا الفعل والذنب الكبير يقدحون في الأنساب، وينتهكون الأعراض البريئة، وينشرون لأولئك الأبرياء سمعة سيئة؛ تقشعر منها الجلود، وتنكس منها الرؤوس حياء وخجلا، مع بعدهم عن تلك الجرائم المزعومة ونزاهتهم عن اقترافها؛ فكانت عقوبة من قذفهم بها الجلد ورد الشهادة، والحكم عليهم بالفسق الذي هو الخروج عن العدالة والطاعة مع استحقاقهم للعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وللعذاب العظيم في الدار الآخرة، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا لهم عن الكذب والافتراء على المؤمنين والاستهتار، والهتك للأعراض؛ فيأمن الناس ويطمئنون في حياتهم، وتتم بينهم المودة والإخاء، وتزول العداوة والشحناء؛ مما يكون سببًا للتقاطع والتدابر والتهاجر الذي جاء الشرع بالنهي عنه وتحريمه؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من اختلال الأمن، ووقوع الفتن، وتسلط الأعداء ونحو ذلك.
وكما شرع -تعالى- عقوبةً وحدًّا مانعًا لمن تعاطى شرب المسكرات بعد أن أوضح تحريم الخمر وما فيها من المفاسد، فقرنها بالأنصاب وهي الأصنام، وأخبر بأنها رجس، أي: نجس وقذر حسي أو معنوي، وأنها من عمل الشيطان، فهو الذي يزينها ويدعو إلى الوقوع فيها، ويوقع بسببها بين المسلمين العداوة والبغضاء، ويصدهم بتعاطيها عن ذكر الله وعن الصلاة، رغم ما فيها من إزالة العقل الذي هو ميزة الإنسان وفضيلته، فبزواله يكون دون البهائم والسفهاء، ويتصرف تصرف المجانين والمعتوهين، فيهلك الحرث والنسل، ويضر بالأنفس والأموال، والأهل والأولاد، وما إلى ذلك من المفاسد الكبرى التي تنتج عن تعاطي المسكرات والمخدرات، ولا يقتصر ضررها على الجاني وحده؛ بل يلحق بالمجتمع أجمع إلا ما شاء الله، فلا جَرَم أن جُرْمه جاء في السنة جلد شارب الخمر بما يزجره، كأربعين جلدة، أو ثمانين إن لم ينزجر بالأربعين، بل ثبت في السنة الأمر بقتله إذا أدمن ذلك ولم ينزجر بتكرار الجلد.
ففي هذه العقوبات والوعيد الشديد عليها ما يكفي في الكف عنها، وما يحفظ للعقول سلامتها، ويبقي -بذلك- على سلامة التفكير، مما يكفل للأمة أمنها ورخاءها، وسلامتها من الأضرار والشرور الوخيمة، والإبقاء على عقول البشر؛ لتصرف تفكيرها فيما يعود عليها وعلى غيرها بكامل الخير والمصلحة، وذلك أكبر مثال على كمال هذه الشريعة، وتضمنها لمصالح العباد.
وهكذا أيضا شرع عقوبة السارق بقوله -تعالى-  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ذلك أن السارق يهتك الأستار والحروز، ويكسر الأقفال ويتسلق الحيطان، ويصعب التحصن والتحرز من شره وضرره، فكانت عقوبته قطع يده، تلك اليد الآثمة المتعدية الظالمة، حيث إن جنايته تتوقف على العمل باليد غالبًا؛ فكان بقاء هذا العضو المعتدي مما ينشر الوباء ويخل بالأمن والاطمئنان على الأموال المحترمة التي لها وقع في النفوس، فأخذها عدوانا وظلما مما يوقع الخوف والقلق في القلوب، فشرع إزالة هذا العضو الذي ينشر الوباء والمرض العضال بين الناس.
ذلك أن السارق يهتك الأستار والحروز، ويكسر الأقفال ويتسلق الحيطان، ويصعب التحصن والتحرز من شره وضرره، فكانت عقوبته قطع يده، تلك اليد الآثمة المتعدية الظالمة، حيث إن جنايته تتوقف على العمل باليد غالبًا؛ فكان بقاء هذا العضو المعتدي مما ينشر الوباء ويخل بالأمن والاطمئنان على الأموال المحترمة التي لها وقع في النفوس، فأخذها عدوانا وظلما مما يوقع الخوف والقلق في القلوب، فشرع إزالة هذا العضو الذي ينشر الوباء والمرض العضال بين الناس.
وكما اشتمل الشرع على هذه العقوبات والزواجر التي يحصل بتطبيقها كمال الأمن ورخاء العيش؛ فقد شرع عقوبات أخرى غير مقدرة بعدد أو نوع، تسمى تعزيرا وتأديبا، يعاقب بها من اقترف ذنبا أو ارتكب كبيرة لا حد فيها، مما يتعلق بالأديان أو الأبدان أو الأموال، وتتفاوت تلك العقوبات بتفاوت الجرائم والمجرمين، وكل هذه العقوبات -مقدرة أو غير مقدرة- تتضح فيها حكمة الشرع الشريف، ويتضح لكل ذي قلب سليم أنه دين سماوي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وإلغاء المفاسد وتقليلها.