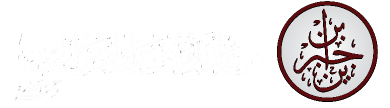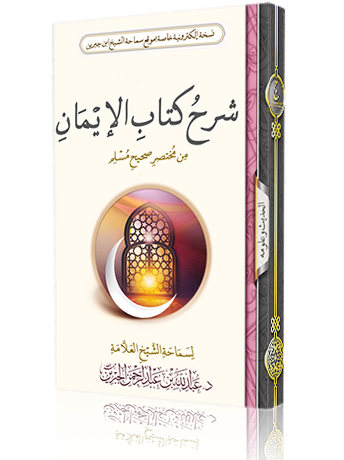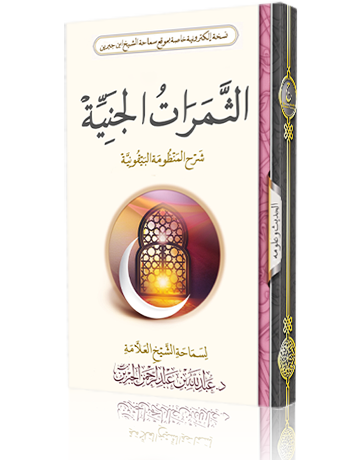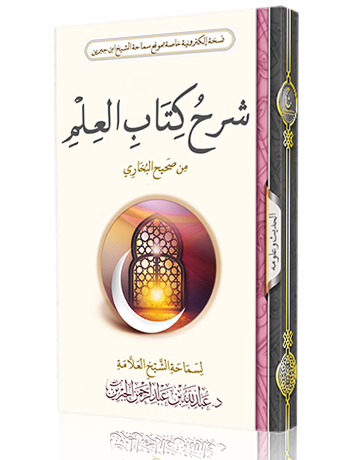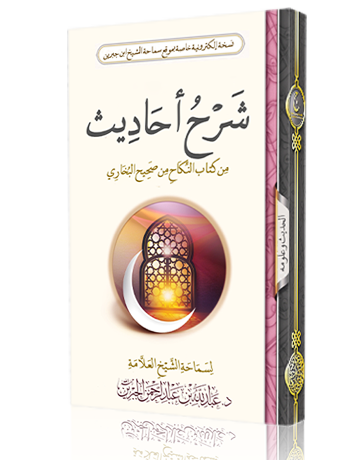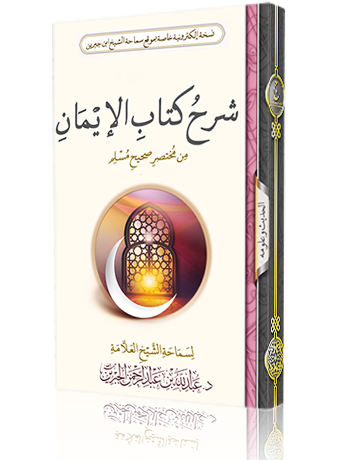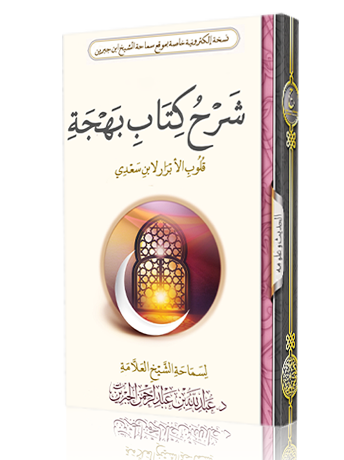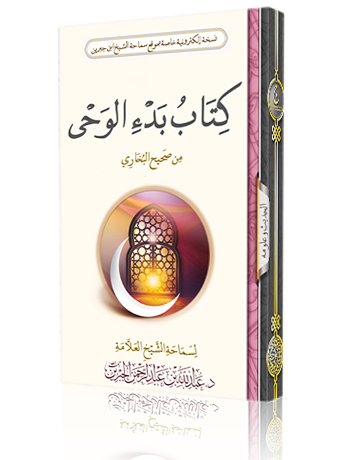شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري

باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل
قال البخاري -رحمه الله تعالى- باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل؛ لقوله تعالى:  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره:
فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره:  إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 
 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد -رضي الله عنه-
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد -رضي الله عنه-  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيرُه أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيرُه أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار  ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخِي الزهري عن الزهري .
ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخِي الزهري عن الزهري .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الآية في سورة الحجرات:
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  قيل: إن هؤلاء كانوا منافقين آمنوا بألسنةٍ ظاهرًا ولم تؤمن قلوبهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فلأجل ذلك أنكر الله عليهم قولهم:
قيل: إن هؤلاء كانوا منافقين آمنوا بألسنةٍ ظاهرًا ولم تؤمن قلوبهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فلأجل ذلك أنكر الله عليهم قولهم:  آمَنَّا
آمَنَّا  فقال: إنكم
فقال: إنكم  لَمْ تُؤْمِنُوا
لَمْ تُؤْمِنُوا  وإنما قولوا:
وإنما قولوا:  أَسْلَمْنَا
أَسْلَمْنَا  فإن (الإسلام): يكون هو الأعمال الظاهرة الاستسلام في الظاهر، بمعنى: أنكم دخلتم في مسمى الإسلام حيث استسلمتم وعملتم بالأعمال الظاهرة، ولكن قلوبكم لم تطمئن بالإيمان،
فإن (الإسلام): يكون هو الأعمال الظاهرة الاستسلام في الظاهر، بمعنى: أنكم دخلتم في مسمى الإسلام حيث استسلمتم وعملتم بالأعمال الظاهرة، ولكن قلوبكم لم تطمئن بالإيمان،  وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  ولم تنشرح به ولم تصدقوا به يقينا ولم تتبعوه عن قناعة، بل أنتم مترددون في شك من دينكم، فلا تقولوا:
ولم تنشرح به ولم تصدقوا به يقينا ولم تتبعوه عن قناعة، بل أنتم مترددون في شك من دينكم، فلا تقولوا:  آمَنَّا
آمَنَّا  وإنما تقولون:
وإنما تقولون:  أَسْلَمْنَا
أَسْلَمْنَا  يعني: استسلاما ظاهرا.
يعني: استسلاما ظاهرا. وكان كثير من المنافقين وكثير من الأعراب دخلوا في الإسلام كتجربة؛ بمعنى: أنهم يقولون: حيث إن الإسلام قد ظهر وصار له تمكن، وتَمَكَّنَ محمد ومن معه وغلبوا على كثير من البلاد فندخل معهم، وإن كنا لم نطمئن بصحة ما هم فيه، وإنما نستسلم لهم غير معتقدين صحة ما هم عليه.
فكثير منهم كالمنافقين، قال الله تعالى:
 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ  .
. الأعراب: هم البوادي الذين يتنقلون من مكان لمكان. في هذه الآية:
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  يدل على أنهم غير مؤمنين، أنهم غير متبعين للحق كله؛ ولهذا قال:
يدل على أنهم غير مؤمنين، أنهم غير متبعين للحق كله؛ ولهذا قال:  الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ  يعني: أنهم أشد من غيرهم كفرا ونفاقا.
يعني: أنهم أشد من غيرهم كفرا ونفاقا. ولهذا لا يتقبلون كل ما جاء في القرآن أو في الإسلام، وإنما يعملون بما يناسبهم، وقال:
 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا  الذي ينفقونه من أموالهم يتخذونه مغرما، كأنهم غُرِّمُوا قهرا وغصبا عليهم فلا يحتسبون بما ينفقون، ولا يجعلون له أجرا، ولا يرون أنهم بحاجة إلى عمل في الآخرة، وقد يكونون في شك من البعث بعد الموت، وقد يكونون يحبون الكفار في باطن قلوبهم أشد حبا من المؤمنين، وإذا جاهدوا فلا يجاهدون لأجل نصر الدين، وإنما يجاهدون لأجل المغنم لأجل ما يحصل لهم من الغنيمة ويجاهدون .. على أمر دنيوي، وأشباه ذلك من أعمال المنافقين.
الذي ينفقونه من أموالهم يتخذونه مغرما، كأنهم غُرِّمُوا قهرا وغصبا عليهم فلا يحتسبون بما ينفقون، ولا يجعلون له أجرا، ولا يرون أنهم بحاجة إلى عمل في الآخرة، وقد يكونون في شك من البعث بعد الموت، وقد يكونون يحبون الكفار في باطن قلوبهم أشد حبا من المؤمنين، وإذا جاهدوا فلا يجاهدون لأجل نصر الدين، وإنما يجاهدون لأجل المغنم لأجل ما يحصل لهم من الغنيمة ويجاهدون .. على أمر دنيوي، وأشباه ذلك من أعمال المنافقين. فهذا هو السبب في أن الله قال:
 قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  نحن نعاملهم بالظاهر والنبي -صلى الله عليه وسلم- يعاملهم بالظاهر ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، فهو يقبل علانيتهم ويكل سرهم إلى الله، هكذا جاء في هذه الآية.
نحن نعاملهم بالظاهر والنبي -صلى الله عليه وسلم- يعاملهم بالظاهر ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، فهو يقبل علانيتهم ويكل سرهم إلى الله، هكذا جاء في هذه الآية. لا شك أن هناك منهم من اطمأن بالإيمان وأحبه وركن إليه؛ ولهذا قال في الآية الأخرى:
 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ  يعني: منهم من هم مؤمنون حقا، يعتقدون أن ما ينفقونه وما يؤخذ منهم من أموالهم قربات تقربهم إلى رضا الله تعالى، مع أنهم يؤمنون إيمانا حقيقيا بالله وبرسوله وبأركان الإيمان، فلا بد أن يكون في الأعراب من دخل الإيمان في قلوبهم، ولكن الأكثر أنهم أجدر على ما ذكره الله:
يعني: منهم من هم مؤمنون حقا، يعتقدون أن ما ينفقونه وما يؤخذ منهم من أموالهم قربات تقربهم إلى رضا الله تعالى، مع أنهم يؤمنون إيمانا حقيقيا بالله وبرسوله وبأركان الإيمان، فلا بد أن يكون في الأعراب من دخل الإيمان في قلوبهم، ولكن الأكثر أنهم أجدر على ما ذكره الله:  الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا
الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا  .
. وأما حديث سعد في هذه القصة جاءت للنبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة دراهم من فضة أو دنانير، وكان حوله بعض الناس فأخذ يعطي هذا وهذا وهذا وهذا، وترك منهم واحدا يعرف منه سعد أنه مستحق وأنه أحق من غيره، فاستغرب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك هذا وأعطى هؤلاء، فزكاه عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال:
 ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- أو مسلما
ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- أو مسلما  يعني: لا تقل: مؤمنا فالإيمان خفي، ولكن تشهد له بالإسلام الظاهر ولا تزكيه في الباطن، قل: إنه مسلم، لا تقل: إنه مؤمن.
يعني: لا تقل: مؤمنا فالإيمان خفي، ولكن تشهد له بالإسلام الظاهر ولا تزكيه في الباطن، قل: إنه مسلم، لا تقل: إنه مؤمن. عند ذلك سكت سعد ثم إنه كرر عليه هذه الكلمة:
 ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فكرر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: أو مسلما
ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فكرر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: أو مسلما  إلى ثلاث مرات. فكأنه يعرف سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- يعرف منه صحة الإيمان، وذلك لما رأى أو يرى من كثرة أعماله أنه يصوم ويتصدق وأنه يصلي ويتنفل ويجاهد ويترك المحرمات؛ فجزم بأنه مؤمن، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
إلى ثلاث مرات. فكأنه يعرف سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- يعرف منه صحة الإيمان، وذلك لما رأى أو يرى من كثرة أعماله أنه يصوم ويتصدق وأنه يصلي ويتنفل ويجاهد ويترك المحرمات؛ فجزم بأنه مؤمن، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:  أو مسلما
أو مسلما  يعني: لا يكون مؤمنا..، ولكن اجزم بأنه مسلم لأنك تشاهد أعماله الظاهرة، وأما ما في القلب فلا تجزم به وذلك لأنه خفي لا يعلمه إلا الله.
يعني: لا يكون مؤمنا..، ولكن اجزم بأنه مسلم لأنك تشاهد أعماله الظاهرة، وأما ما في القلب فلا تجزم به وذلك لأنه خفي لا يعلمه إلا الله. قد يستدل بهذا وبالآية على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وأن (الإسلام) هو الأعمال الظاهرة، وأن (الإيمان) هو ما يكون في القلب، هو ما كان في القلب على ما يقول به المرجئة مرجئة الفقهاء.
ولكن نقول: إن الإيمان الذي يكون في القلب هو الذي يثمر كثرة الأعمال، فتكون الأعمال داخلة في الإيمان، وهو ما يختاره أهل السنة، ولهذا البخاري -رحمه الله- يذكر أبوابا كثيرة في خصال الإيمان، وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني فيقول: الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، مع أنها أعمال بدنية أو مالية.
وكذلك الشهادتان من الإيمان، الذكر من الإيمان، مع أنها كلمات قولية، وكذلك حب الله ورسوله من الإيمان، كراهة الكفر من الإيمان، والحياء من الإيمان مع أنها أعمال قلبية.
في هذا الحديث اعتذر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عدم إعطائه لهذا الرجل، اعتذر عن تركه لهذا الرجل:
 إني لأعطي قوما وأترك آخرين، والذين أتركهم أحب إلي من الذين أعطيهم؛ مخافة أن يكبهم الله في النار
إني لأعطي قوما وأترك آخرين، والذين أتركهم أحب إلي من الذين أعطيهم؛ مخافة أن يكبهم الله في النار  يعني: أن هؤلاء الذين أعطاهم كأنهم من الذين قال الله:
يعني: أن هؤلاء الذين أعطاهم كأنهم من الذين قال الله:  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ  فهو يخشى أنهم إذا تركهم ارتدوا، وقالوا: لا يعطينا من المال الذي يعطيه الله الذي عنده، فيرتدون ويكفرون ويلحقون بالكفار ويموتون على الكفر، ويلقيهم الله تعالى في النار، ويكون ذلك سببا في كفرهم فهو يعطيهم حتى يرغبهم يعطيهم من الصدقات والزكوات والنفقات والواردات المالية التي ترد عليه فيعطيهم لضعف إيمانهم، ويترك من هم أقوى إيمانا يترك القوي إيمانه؛ لأن إيمانهم يحميهم عن الردة وعن الكفر.
فهو يخشى أنهم إذا تركهم ارتدوا، وقالوا: لا يعطينا من المال الذي يعطيه الله الذي عنده، فيرتدون ويكفرون ويلحقون بالكفار ويموتون على الكفر، ويلقيهم الله تعالى في النار، ويكون ذلك سببا في كفرهم فهو يعطيهم حتى يرغبهم يعطيهم من الصدقات والزكوات والنفقات والواردات المالية التي ترد عليه فيعطيهم لضعف إيمانهم، ويترك من هم أقوى إيمانا يترك القوي إيمانه؛ لأن إيمانهم يحميهم عن الردة وعن الكفر. هكذا اعتذر، وإلا فإنه يعرف أن هذا الرجل الذي ترك أحسن حالا أو أقوى إيمانا من الذين أعطاهم.